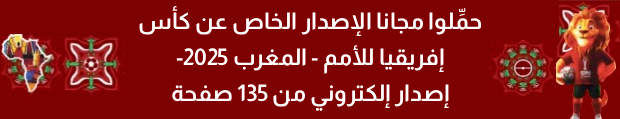لا أذكر أنني مرة بالغت في التهليل أو التطبيل للإطار التقني الوطني، أو حتى أنني كنت محاميا للشيطان، أستنصر الكفاءة المغربية ولا أرى غيرها أهلا بأن تناط بها مهمة تأطير الشباب المغربي.
لم يمر علي أن كنت متطرفا في الدفاع عن الإطار التقني المغربي إلى الحد الذي يجعلني أعارض مبدإ الإنفتاح على مدربين من جنسيات مختلفة، وكيف أفعل وأنا من عاش وجايل وعاصر مدربين أجانب كثر مروا على المنتخب الوطني وعلى الأندية وتركوا ما هو محفوظ في ذاكرتنا جميعا، من عمل إحترافي وتقني أسهم في تلميع صورة الكرة الوطنية بفرقها ولاعبيها.
لذلك لم يكن غريبا علينا في «المنتخب» أننا من البداية رافقنا هشام الدكيك في رحلته الطويلة والعسيرة من أجل تحقيق حلمه الكبير، رحلة ليس منتهاها الوصول بكرة القدم داخل القاعة إلى العالمية، ولكن تثبيت الفوت صال في ثقافتنا الكروية، أي أن تكف الأجهزة الوصية على النظر إليها كالمعي الزائد، فيوم لم يكن أحد يسمع همس هشام ولا صدى الحلم المنطلق من ضلوعه، كانت «المنتخب» ترصد حركاته وسكناته، بل وتحصي أنفاسه بغاية حماية آماله من الإنكسار على صخرة التنكر واللامبالاة.
شخصيا تعرفت على هشام الدكيك وعلى مساحات انشغالاته بكرة القاعة، من خلال الزميل محمد الجفال، فقد حدث لمرات عديدة أن استمات الزميل الجفال في الدفاع عن أهلية الدكيك، معجبا بسقف طموحاته، لم يفعل ذلك فقط بأن جعل لصوت الرجاء الذي بداخل هشام صدى في جريدة «المنتخب» مما يذكره الدكيك بامتنان وعرفان، بأن لا يفوت فرصة لإظهار ملكاته التقنية والأخلاقية مؤطرا ومربيا، ولكن بأن فتح جبهة داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لحماية الرجل من الذين باعوا جلده وأحلامه ونسفوا عن عمد طموحه بأحكام قيمة، وهم اليوم في مرحلة عذاب وتأنيب ضمير لأنهم لم يقدروا الرجل قبل سنوات حق قدره، بل رموه بظلم هو نفسه الذي قال فيه الشاعر طرفة بن العبد، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند.
الذين يحتفلون اليوم بهشام الدكيك ويرفعونه فوق الرؤوس ويمسحون دموع الفرح والسعادة التي تنهمر من عينيه، وهو أهل لذلك، لأنه أهدى بأسوده كل المغاربة سعادة ذكرتهم بليالي المونديال الحالمة بالمكسيك وفرنسا، كل هؤلاء عليهم أن يعرفوا أن شقائق النعمان التي أهدانا إياها الدكيك خرجت من عتمة الظلام، من قبو مدلهم وحالك السواد، كان يأوي إليه هشام ليشكو لمن خلقه ظلم من تسلطوا على الفوت صال وأصبحوا له بين عشية وضحاها وكلاء وأوصياء وسماسرة.
غير الإبداع الخططي والنبوغ الفكري في إدارة المباريات وهندسة الإنجاز التاريخي لأسود القاعة وهم يبلغون ربع نهائي كأس العالم، هناك هشام الدكيك الإنسان الذي قاوم انجرافات التربة الرياضية وقاوم المتسلطين والوصوليين والإنتهازيين وتجار النجاح، وصمد أمام أعتى الرياح، ليجعل شمس الفوت صال المغربي تشرق على ربوات العالم من خلال مونديال ليثوانيا.
أنا هنا أستحضر الوجع الذي عاش بداخل هشام الدكيك زمنا طويلا، أتحدث عن قلب هذا الرجل الذي لم ينكسر وعن حلمه الكبير الذي لم تصبه التعرية من فرط ما هب عليه من رياح فاسدة، واليوم إذا كان هشام الدكيك قد نجح في إنهاء المخاض العسير، فإنه بالقطع يدين في ذلك بعد الله، لإرادته التي لا تلين وعلى الخصوص للسيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الذي آمن بكفاءته ووثق من أهليته، فحماه من جشع المتاجرين بالنجاح ومكنه مما لم يكن هو أصلا يحلم به من إمكانيات مادية ولوجيستية لكي يرتفع زئير أسود الأطلس عاليا في المنصة المونديالية.
عفوا.. أنا من يعرف هشام الدكيك، فصدره وقلبه وعقله يتسعون لأحلام أخرى، فإن جعل سقف الطموح يصل إلى الرهان على لقب كأس العالم، كذب في ذلك كل من قالوا ظلما وجهلا وعبثا قبل سنوات أنه لا يصلح مدربا للمنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة، مع أن كل أولئك دخلوا جحورهم، أو بالأحرى ماتوا بسمهم..
الدكيك لا يصلح مدربا!

تنبيه هام
تؤكد «المنتخب» أنها تمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر مواضيع أو صور منقولة من نسختها الورقية أو من موقعها الإلكتروني سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل.
النسخة الالكترونية للجريدة
زوايا الرأي
حاليا في الأكشاك
| الفريق | ل | ف | ت | خ | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |

|
المغرب الفاسي | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 |
| 2 |

|
الوداد الرياضي | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
| 3 |

|
الرجاء الرياضي | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 |
| 4 |

|
الجيش الملكي | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 |
| 5 |

|
النادي المكناسي | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 6 |

|
الدفاع الحسني الجديدي | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 7 |

|
اتحاد طنجة | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 |
| 8 |

|
نهضة بركان | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 9 |

|
أولمبيك الدشيرة | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 10 |

|
حسنية أكادير | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 11 |

|
الكوكب المراكشي | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 12 |

|
نهضة الزمامرة | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 13 |

|
اتحاد الفتح الرياضي | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 14 |

|
إتحاد تواركة | 10 | 0 | 7 | 3 | 7 |
| 15 |

|
الإتحاد الرياضي يعقوب المنصور | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 16 |

|
أولمبيك آسفي | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
- دوري أبطال أفريقيا
- كأس الاتحاد الأفريقي
- تصفيات الهبوط
- الهبوط
|
الجيش الملكي

|
|
 الوداد الرياضي
الوداد الرياضي
|
|
الرجاء الرياضي

|
1 - 2
|
 إتحاد طنجة
إتحاد طنجة
|