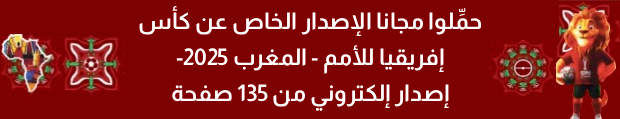إن تقاسمنا الخيبة مما شاهدناه في الكأس الإفريقية الأخيرة بكوت ديفوار، والفريق الوطني يغادرها صاغرا ومقصيا من الدور ثمن النهائي، بعد الخسارة من «الأولاد».
وإن اختلفنا في ضرورة تجديد الثقة في وليد الركراكي مدربا وناخبا وطنيا للمرحلة القادمة والتي تقود أسود الأطلس، إلى سباقين، أحدهما نرجو أن يكلل بالتأهل لمونديال 2026، والثاني نتطلع لأن تكون خاتمته الجميلة، الصعود لأعلى منصات التتويج في النسخة التي سنستضيفها لكأس إفريقيا للأمم العام المقبل، رافعين الكأس القارية التي استعصت علينا منذ سنة 1976.
إن تباينت بيننا الرؤى المستقبلية، فلا يمكن بالقطع أن نقبل بما ذهب إليه البعض، من أن الإخفاق في الكان أزاح الشجرة التي تخفي غابة مقفرة، لا ماء ولا زرع فيها، وكرس الوضع الشاذ الذي يلازم كرة القدم الوطنية، من أنها تفتقد لسياسة، لرؤية وكذا لاستراتيجية.
لا يمكن قطعا القبول بهذه الخلاصة، لأن هناك بالفعل ما يدحضها، ولا أقصد هنا الفكر النقدي السليم الذي يحظر إسقاط الصرح وهدم المعبد فوق الرؤوس، لمجرد خسارة لمباراة أو حتى لرهان رياضي، ولكن لأن هناك حقائق دامغة ومتجلية لا يمكن القفز عليها ونحن نشرح ونحلل سقطة الكان، وأولها أن كرة القدم الوطنية تعيش واحدة من أكثر الفترات في زمنها الطويل، ارتباطا برؤية واستراتيجية مؤسسة بالفعل على سياسة كروية، قد لا تكون كل الرؤية سليمة، وقد لا تكون كل الأوراش ناجحة، ولكن كل ما هو ماثل أمامنا بخاصة على مستوى منتخباتنا الوطنية، يقول أن الطفرة التي حدثت لا يمكن أبدا أن تكون من صنيع الصدفة، وأنها نتاج لسياسة وضعت بإحكام، وتهيأت لها كل الظروف لكي تثمر كل هذا الذي نشاهده من نجاحات عالمية وقارية، نجاحات إن قابلها فشل ما، لا تترك مجالا للتشكيك في صحة الرؤية، بل تدعو لمواصلة العمل بلا هوادة.
قبل أن يسقط المنتخب الوطني في امتحانه القاري لوجود قوة قاهرة، ولوجود معطلات ذاتية أسهبنا في الحديث عنها، فإن ذات المنتخب هو من أبهر العالم كله بوصوله للمربع الذهبي للمونديال، ولا أظن أن الشجرة أثمرت وأورقت عالميا من دون أن ترتوي من ماء العمل.
وهذا منتخبنا لأقل من 23 سنة يتوج بطلا لإفريقيا لأول مرة في تاريخه، ويقتطع تذكرة التأهل للأولمبياد الذي غابت عنه كرة القدم المغربية لدورتين متتاليتين، ونجح منتخب أقل من 17 سنة في نيل وصافة بطل إفريقيا لأول مرة، بل إنه سيضيف لذلك إنجازا آخر تمثل في بلوغه الدور ربع النهائي لكأس العالم. وكان الحدث الإستثنائي الذي لم يتكرر من قبل أن كل المنتخبات النسوية (كبيرات، أقل من 20 سنة وأقل من 17 سنة) بلغت كأس العالم وحققت في ذلك إنجازا عربيا غير مسبوق، وقد تخطى منتخب الكبيرات ومنتخب أقل من 17 سنة دور المجموعات، وتقاتل لبؤات الأطلس من أجل إنجاز كروي جديد، بإقران الحضور في المونديال مع التواجد لأول مرة بالأولمبياد.
ولا يمكن بالقطع، أن ننسب كل الذي يفعله المنتخب المغربي للفوتصال من عجائب في كرة القاعة، وهو يتوج مرتين متتاليتين باللقبين الإفريقي والعربي، ويبلغ الدور ربع النهائي لكأس العالم الأخيرة، لا يمكن أن ننسب كل ذلك وفقط لعبقرية مدربه الكبير هشام الدكيك وللجيل المبهر من اللاعبين، من دون أن نذكر جيدا في أي فيافي كان هذا المنتخب، وإلى أي نعيم أتى، وهو يجد كل مسببات النبوغ والإبهار.
لا أذكر في عقودي الأربعة التي قضيتها في المشهد الإعلامي الرياضي ناقدا ومواكبا، أنه كانت لكرة القدم الوطنية فترة بمثل هذه الخصوبة، أي أو تتحقق الإنجازات والعالمية لكل مفاصل الممارسة، فبعد النجاحات الكبيرة التي تحققت للأندية الوطنية في العشرية الأخيرة، ها هي المنتخبات الوطنية تراكم النجاحات، معتمدة في ذلك على عمل قاعدي وهيكلي، وعلى رؤية متبصرة واستراتيجية قامت على عمادات سياسة كروية مسنودة إلى إرادة جماعية.
إن الإخفاق القاري على مرارته، يمثل وجعا لنا جميعا، لكنه بكل الأحوال، لا يمكن أن يجني على عمل سنوات طويلة، لا يمكن أن يحبط عزيمة ولا أن يقوض صرحا، فالعمل يجب أن يتواصل ودائما بنفس الإحترافية، على أمل أن يحظى ورش الأندية الوطنية بانكباب جماعي لانتشال الإحتراف من المزالق التي دخل إليها، وذاك موضوع آخر سأعود إليه لاحقا.